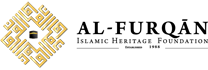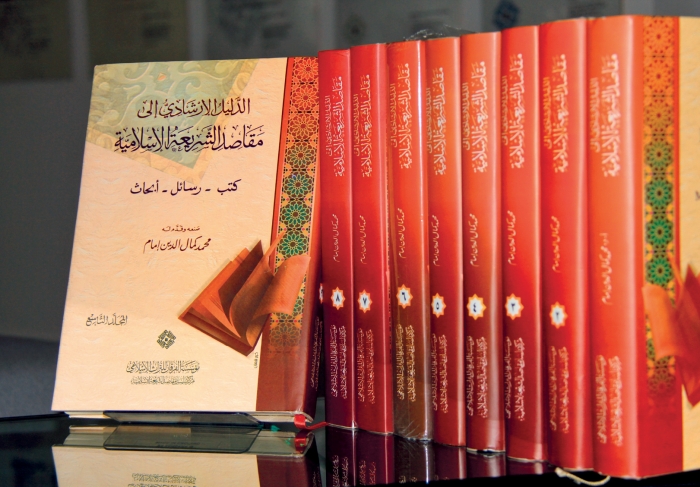أثر الجهالة والضرورة في المعاملات المالية | |
| د. محمد محمود سليمان المحمد | |
| Publication Details: | Place: الإمارات العربية المتحدة الشارقة Name: مكتبة الصحابة |
| Language: | Arabic |
| Edition: | ١ |
| Year of 1st Edition: | ١٤٢٤ م / ٢٠٠٤ هـ |
| Physical Desc: | No of Pages: ٤١٦ |
| Subject: | تعريف العقد وتكوينه وموقع الإنسان في إنشاء الشروط والعقود أثر الجهالة في عقد البيع أثر الجهالة في بقية المعاملات المالية |
| Madhab: | Maʿāṣir |
| Contributors: | د. محمد محمود سليمان المحمد (تأليف) |
أصل الكتاب رسالة مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية- جامعة بغداد، وجزء من متطلبات درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية والفقه المقارن.
ويتكوَّن الكتاب من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة أبواب. يذكر المؤلف في المقدمة أن من المبادئ المعروفة في الإسلام أن الله تعالى هو مصدر الشرائع والأحكام، سواء أكان طريق معرفة الحكم هو النص الصريح المباشر في القرآن الكريم أو السُّنَّة النبوية، أم اجتهاد المجتهدين؛ لأن عمل المجتهد هو إظهار حكم الله وكشفه، عن طرق الاستنباط العقلي ضمن مقاصد الشريعة.
ومن المعلوم أيضًا أن الله تعالى لا يشرع إلا ما يكون فيه تحقيق مصلحة للناس في العاجل والآجل، ومن يتتبع الأحكام الشرعية يجدها لا تخلو من أمرين، هما: جلب النفع للإنسان، أو دفع الضرر عنه، وقد نعرف تلك المصلحة وقد لا نعرفها.
فكان من رحمة الله تعالى بالناس في التشريع أنه قصد من جملة مقاصده حفظ التوازن بين مصالح الفرد ومصالح الجماعة، فما جعله مباحًا أو واجبًا على الإنسان، فلا بد أن يكون فيه نفع له، إما أن يكون نفعًا محضًا، وإما أن يكون نفعه أكثر من ضرره، وإما أن يحقق نفعًا لأكبر مجموعة من الناس.
وما جعله حرامًا أو مكروهًا فلأنه شر محض، أو لأن ضرره أكثر من نفعه، أو لأنه ضار بمصلحة أكبر مجموعة من الناس.
فتنظيم العقود والتصرفات على ما هي عليه في الشريعة الإسلامية إنما يقصد منه إقامة العدل، ومنع المنازعات وحفظ الحقوق المالية وعدم الاعتداء عليها، والشارع نهى عن الربا لما فيه من الظلم، وعن الميسر لما فيه من الظلم.
فالشريعة إذن حرَّمت كل ما يلحق بالإنسان من نواحي الضرر والشر والفساد، فحرّمت الاعتداء على حقوق الغير، وحرّمت أكل أموال الناس بالباطل، ومنعت كل ما يؤدي إلى نزاع وقطيعة بين الناس كالقمار والربا والغش.
كما حرّمت على الإنسان أن يلحق الضرر بنفسه، سواء كان الضرر في جسده أو عقله أو ماله، فحرّمت الانتحار وشرب الخمر وتبديد الأموال، وإجراء أي نوع من أنواع التعامل على الأعضاء والدم، كبيع النفس الحرة الكريمة، أو التصرف بعوض في الدم والجوارح، ونحو ذلك مما يتنافى مع كرامته الإنسانية.
وبذلك يكون هدف الشريعة الإسلامية هو إسعاد الفرد والجماعة، وحفظ النظام وإعمار الأرض بكل ما يوصلها إلى أوج مدارج الكمال والخير والمدنية والحضارة؛ ومن هنا كانت دعوة الإسلام رحمة للناس.
يعرض الباحث في التمهيد تعريف العقد وتكوينه، ومدى هوية الإنسان في إنشاء العقود والشروط.
ويذكر معنى الجهالة في اللغة والاصطلاح، وهي تعني: «ما لم يُعلم حصوله من عدمه أو صفته أو أجله»، ولا يفرّق المؤلف بين الجهل والجهالة، فالجهالة تدخل على أركان العقد فتمنع انعقاده، أو ينعقد فاسدًا عند الأحناف، أما الجهل فهو وصف يمكن أن يؤثر على لزوم العقد، أو على أحد البدلين.
عنوان الباب الأول: «أثر الجهالة في عقد البيع» ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول: الأول: أثر الجهالة في صيغ البيع، والثاني: أثر الجهالة في المبيع، أما الفصل الثالث: فهو أثر الجهالة في الثمن.
فالفصل الأول: يستعرض فيه المؤلف أثر الجهالة في صيغة العقد، ويشمل البياعات التالية: 1- بيع المعاطاة. 2- بيع المنابذة. 3- بيع الملامسة. 4- بيع الحصاة.
5- بيع العربون. 6- بيعتان في بيعة. 7- البيع المعلق على شرط والبيع المضاف إلى المستقيل. 8- البيع والسلف.
ويرجح المؤلف صحة بيع العربون بناء على العُرف؛ لأنه أصبح في عصرنا أساسًا للارتباط في التعامل بين البائع والمشتري لكي يضمن التعهد بتعريض ما يلحقه من ضرر نتيجة التعطيل والانتظار، وتفويت فرص البيع من شخص آخر.
كما رجحت صحة بيع المعاطاة في الأشياء الخسيسة لقلّة الجهالة فيها، وعدم صحته في الأشياء النفسية لجهالة الرضا. أما بيع المنابذة والملامسة والحصاة فهي بيوع كانت في الجاهلية، فجاء الإسلام وأبطلها.
وفي الفصل الثاني يتكلم المؤلف عن أثر الجهالة في المبيع. والفقهاء اشترطوا العلم بمقدار البيع.
وفي الفصل الثالث يعرض المؤلف أثر الجهالة في الثمن، وأن الفقهاء متفقون على أن معرفة وصف الثمن شرط في صحة البيع.
أما الباب الثاني فعنوانه: «أثر الجهالة في بقية المعاملات المالية»، ويشتمل هذا الباب على ستة فصول:
ففي الفصل الأول يتكلم المؤلف عن أثر الجهالة في عقود المعاوضات المالية عدا البيع، وقد شمل عقد السلم والاستصناع والإجارة والجعالة والصلح، ويبيِّن أن عقد السلم شرع على خلاف القياس لكونه بيع معدوم، إلا أنه ثبتت شرعيته بالكتاب والسُّنَّة والإجماع، ثم بيِّن حكمه وشروطه، وأن أقل الآجال في السلم شهر أو ما يقاربه؛ لأن الأجل إنما اعتبر لتحقيق ما شُرع لأجله، وهو الترفيه والتيسير على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في هذه المدة، ثم يتكلم المؤلف عن الاستصناع وحكمه وشروطه وصفته، ثم عن الإجارة وأركانها وحكمها.
ويخلص المؤلف إلى أن إجارة الأرض جائزة مطلقًا سواء كان العوض ذهبًا أو فضة أو عروضًا وطعامًا مما يخرج من الأرض أو من غيرها إلا إذا كان العقد شرطًا لا يقتضيه كأن يشترط صاحب الأرض على المستأجر عاملاً بعينه، وتكلم عن استئجار الدابة للركوب واختلاف الفقهاء في ذلك أيضًا.
كما يتناول المؤلف موضوع الجعالة، وحكمها واختلاف الفقهاء في جوازها، وشروطها، وتعليق الجعل بمدة معلومة، ثم يذكر الفروق بينها وبين الإجارة والجهالة مانعة من التسليم وهي تؤدي إلى المنازعة، فلا يحصل مقصود الصلح، ويذكر أنه يجوز الصلح إذا كان المصالح عنه مجهولاً، ولا يمكن التوصل إلى معرفته؛ لأن في منعه إسقاط حق من له الحق وتركه لمن ليس له.
وفي الفصل الثاني يتناول المؤلف أثر الجهالة في عقـود المشاركات، فيتكلم عن تعريفها ومشروعيتها وأقسامها، ويتوصل إلى عدم جواز شركة المقارضة، لأنه ليس من المعقول ولا المنقول أن يتحمل إنسان جناية إنسان آخر أو قيمة ما أتلف أو ضمان ما غصب زيادة على ذلك أن هذه الشركة متعسرة الوجود إن لم يكن متعذرة التحقيق.
ثم يتكلم المؤلف عن المزارعة وركنها وصفتها، وحكمها واختلاف الفقهاء في جوازها ويخلص إلى جواز عقد المزارعة؛ لأنه يحقق مصالح الناس، فإن كثيرًا من الناس يملكون الأرض ولا يستطيعون العمل بها، ويصعب عليهم دفعها دون مقابل إلى غيرهم، وكذا فإن كثيرًا من الناس يقدرون على العمل ولا أرض لهم؛ لذا فهي تحقق مصلحة الطرفين.
ويعرض المؤلف في الفصل الثالث لأثر الجهالة في عقود الاستيثاق، ويذكر أن المضمون به إذا كانت جهالته فاحشة من كل وجه لا يصح الضمان؛ لأن الضامن إذا ضمن وتبين له أن المضمون به خارج عن استطاعته، فإنه يقع في ضيق وحرج شديدين، مما يضطره إلى مطالبته المضمون عنه أو التهرب من المضمون له. أما الفصل الرابع فهو عن أثر الجهالة في عقود التبرعات. والفصل الخامس عن أثر الجهل في عقود الإطلالات، وذلك في مبحث واحد هو الوكالة.
ويتناول الفصل السادس أثر الضرورة في المعاملات المالية، ويُعرِّف المؤلف في المبحث الأول معنى الضرورة وشروطها، وفي المبحث الثاني يتحدث عن بيع التلجئة والمضطر، وبيع وشراء الدم أو عضو من أعضاء الإنسان للضرورة، ويبيِّن أنه لا يجوز بيع ذلك حتى للضرورة، أما المضطر فيجوز له أن يشتري ما ينقذ حياته من غيره، ويحرم على البائع أخذ الثمن، ثم يعرض الباحث لشراء المحرمات للضرورة، ويخلص إلى جواز شرائها، وحرم على البائع أخذ الثمن، كما يجوز شراء المحرمات لضرورة التداوي على قول الظاهرية، وكذا عند الحنفية والشافعية إذا تعينت هذه المحرمات كوسيلة للشفاء بها، وعدم وجود غيرها من المباحات، أما على قول المالكية والحنابلة فلا يجوز شراؤها؛ لأنهم لا يجيزون التداوي بها إلا إذا أحرقت عند المالكـية.
أما بيع الثمار والزروع المتلاحقة للضرورة والخلاف فيها فيتناوله المؤلف، وكذلك يعرض المؤلف لتصرف الوصي أو الأب في مال القاصر وحدوده، ويتكلم عن تسعير السلع للضرورة.